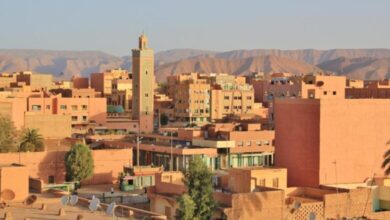حرية التعبير وإكراهات الصحافة بالمغرب بين القانون والممارسة

محسن بالقسم
تحظى المناشدة بتوسيع نطاق حرية الصحافة بالمغرب أولوية قصوى للجهات الفاعلة في مجال الصحافة والإعلام، حيث تعد حرية التعبير والرأي من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير والاتفاقيات الدولية، كما تعد أحد أركان الديمقراطية والحوكمة الشفافة.
من هذا المنطلق، تكفل دستور 2011 في فصله 28، حق حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، وأكد حرص الدولة في تعزيز هذه الحقوق، وهي المقتضيات والأحكام الدستورية التي وجدت ترجمتها بصدور القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ومع ذلك، تظل هناك إكراهات تؤثر على ممارسة الصحافة بالمغرب وتقيد حريتها بين القانون والممارسة، وذلك ما ترجمته التصنيفات العالمية، إذ أن المغرب احتل المرتبة الـ144 عالميا في “مؤشر حرية الصحافة”، بحسب تقرير “مراسلون بلا حدود” للسنة الجارية، بعدما كان في المركز 135 العام الماضي، هذا التقرير الذي ييقيم ظروف ممارسة النشاط الإعلامي في 180 بلدا، أظهر تراجع المغرب بـ 9 مراتب مما كان عليه.
ممارسة الصحافة بالمغرب وحرية الرأي والتعبير وجهان لعملة واحدة
تكمن أهمية حرية التعبير في اعتبارها حقا ضروريا لترسيخ الحقوق الإنسانية الأخرى كما هي مقررة في البنود والمواثيق والعهود الدولية. تهدف حرية التعبير إلى صون كرامة الفرد في حياته وإتاحة فهم أوسع للعالم وللأخر من خلال تداول وتبادل الأفكار والمعلومات بحرية مع الآخرين. كما أن حرية التعبير تعد مقياسا بالنسبة للمجتمع الدولي لقدرة الدول على الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحسین إدارة الحكومة، وأساس للمجتمع الحر والديمقراطي القادر على حرية المناقشة العمومية وتدبير السلطة بشكل سلمي، وتمكين المواطن من تقرير مصيره وفق إرادته الحرة و اختياراته الحرة والمسؤولة دون أي وصاية أو حجر لأفكاره وضميره أو لجسده.
لقد نص الدستور في ديباجته وفي الباب الثاني بصفة خاصة على عدد من الحقوق وربط ممارستها بالقوانين التي تنظمها. فبالنسبة لحرية الرأي والتعبير ينص الفصل 25 من الدستور على أن “حرية الفكر والتعير مكفوله بكل أشکاها”، ويضيف الفصل 28 أن “حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية ومن غير قيد، ما عدا ما ينص عليه القانون صراحة.” كما ينص الدستور على أن ” للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى قانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحدها القانون بدقة”.
وهكذا ثمن المهتمون بحقوق الإنسان ما ورد في الباب الثاني من الوثيقة الدستورية واعتبروه قيمة مضافة، كما سجلوا تقدم الدستور التشريعي وإيجابية مواده وبنوده مقارنة مع الدساتير السابقة. لكن المشكل الجوهري الذي يطرح مرتبط بالتفعيل الديمقراطي لمنظومة الحقوق والحريات، وكذا ضرورة تلازم التفعيل بفصل عملي للسلط وبتشريع قوانين ديمقراطية تنظم الواقع الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي.
وعلى الرغم من اتساع دائرة حرية التعبير والتظاهر خصوصا في السنوات الأولى لاعتلاء محمد السادس الحكم، حيث سارعت الدولة المغربية نحو تسويق صورة سياسية لدولة تحترم حقوق الإنسان وتخضع للمواثيق الدولية وضوابط دولة الحق والقانون، إلا أن أحداث 16 ماي 2003 الدامية ستعيد ملف الانتهاكات وحرية التعبير إلى سابق عهدها، وما استتبع ذلك من اعتقالات واسعة خصوصا بعد مصادقة البرلمان على ما سمي بقانون الإرهاب، حيث أوجدت الدولة لنفسها ترسانة قانونية تجرم العمل الصحافي، إذ بدأت مضايقة الصحافيين وخصوصا أصحاب الآراء التي تمس ثوابت واستراتيجيات النخب المسيطرة على الحكم، وطفت على السطح قضية المقدسات والخطوط الحمراء.
إذا كان الانفتاح السياسي يقتضي توسعا في الفضاء العام واعترافا وحماية للحقوق والحريات السياسية وعلى الخصوص من أجل تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بحرية، فإن الاصلاحات السياسية بالمغرب لا تتناسب إلا جزئيا مع ذلك التعريف، صحيح أن الاصلاحات قد ساهمت في توسيع مجال المشاركة السياسية ووفرت ظروفا أفضل لحقوق الإنسان وللحريات ولكنها لا تضمن بالضرورة حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، حيث تتوقف هذه الحقوق في المغرب عندما يتعلق الأمر بالمقدسات أو ما يعرف عند العامة بالخطوط الحمراء، لذلك فإن الحديث عن الانفتاح قد يبدو مفيدا غير أن العملية تتعرض بانتظام لنكسات ترتبط بفرض غرامات ضد الصحف وفي بعض الأحيان حبس الصحافيين، فإذا كانت الدولة قد اعتمدت برامج للتكيف الهيكلي التي ترتبط بالنظرية الليبرالية في المجال الاقتصادي، إلا أن هذا التوجه الليبرالي لم يتسع بالشكل الكافي ليشمل المجال السياسي.
واقع حرية الصحافة ومآلها
ظهرت القوانين المنظمة للإعلام عقب الاستقلال وكأنها قوانين منفتحة ومدافعة على حرية الإعلام (بالخصوص الإعلام المكتوب ) و لا تبتغي فرض قيود عليه ما عدى ما اقتضته ضرورة المحافظة على الأسس السياسية و الدينية للدولة، ويبدو ذلك واضحا من خلال التشريعات الأولى للإعلام المكتوب، أما الإعلام السمعي البصري فقد ظل محتكرا من قبل الدولة. لكن النفس شبه الليبرالي تم التخلي عنه بتدرج. و السؤال الذي يطرح بهذا الصدد هو هل تشكل قوانين الصحافة قطيعة مع الماضي و تتماشى مع طموحات الدمقرطة المعلن عنها من قبل السلطة؟ أم أنها تجسد حالة التذبذب التي طبعت علاقة الحكومة بالصحافة وبحرية التعبير خلال العقود الماضية؟
إن فحصا أوليا للإطار القانوني والمؤسسي وكذا للممارسات على أرض الواقع يعكس توجها متضاربا. فالدولة لازالت تراقب مضمون وسائل الإعلام وبشكل مباشر من خلال قوانين صارمة ومؤسسات للتقنين تفتقد للاستقلالية الفعلية. فالمغرب لم يبلغ بعد طموح تحریر نظامه الإعلامي الذي فشل في القطع مع تاريخه في استخدام وسائل الإعلام كأداة للدعاية والرقابة السياسية. فإذا كانت الدولة قد سنت قانونا للصحافة يستبعد العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين، وجنبت مواطنيها للإجراءات المتشددة المعتمدة في دول سلطوية أخرى كحجب شبكات التواصل الاجتماعي أو مضمون شبكة الأنترنت، فإنها في الوقت نفسه حافظت على مقتضيات داخل القانون الجنائي تؤدي لسجن الصحافيين، كما أنها تستخدم الضغوطات المالية من خلال فرض غرامات ثقيلة لدفع الإصدارات المطبوعة والإلكترونية الأكثر انتقادا وجرأة للإفلاس من خلال الرقابة على التمويل الإشهاري، كما أدانت صحافيا بتهمة لها علاقة بالإرهاب.
وعلى الرغم من أن قانون الصحافة والنشر الجديد اعترف ولأول مرة بالصحافة الإلكترونية وورد خاليا من العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين، إلا أنه يحتوي على مواد تعتبر مقيدة لحرية التعبير وتهدد بحجب الكثير من المواقع الإلكترونية الإخبارية. ومثال ذلك ما ورد في المادة 15 والتي تفرض على المقاولات الصحافية التوفر على مدير للنشر يعتبر مسؤولا عن كل ما يصدر بالجريدة مع ما يستتبع ذلك من مسؤوليات قانونية، ومن الشروط المفروضة كذلك أن القانون المنظم للصحافة والنشر يفرض على مدير النشر شرطا رئيسيا لكي يتولى مسؤولية إدارة النشر، وهو أن يكون متوفرا على صفة صحافي مهني ( المادة 16) هذا الأخير تعرفه المادة الأولى من النظام الأساسي للصحافييين المهنيين بكونه كل صحافي يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في واحدة أو أكثر من المؤسسات الصحافية، ويكون أجره الأساسي من مزاولة المهنة (قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين) ولو تم إسقاط هذه الشروط على الجرائد والمطبوعات الورقية والصحف الإلكترونية فسوف يتم تنحية العديد من المواقع والعشرات من الجرائد لمخالفتها شروط التأسيس، وهذا ما يعني تحكما بشكل غير مباشر في المشهد الإعلامي وخنقا ممنهجا لحرية التعبير والصحافة.
بالإضافة إلى تلك الشروط الشكلية المرتبطة بتأسيس جريدة إلكترونية، نص قانون الصحافة على جملة من العقوبات والغرامات، وكمثال على ذلك ما ورد في المادة 84 التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، عن كل قذف پرتکب باحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية أو الهيئات المؤسسة أوالمنظمة أو الإدارات العمومية بالمغرب، أو في حق وزير أو عدة وزراء، من أجل مهامهم أو صفاتهم أو في حق موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته”.
حرية الصحافة دعامة أساسية لتعزيز مسار الديمقراطية
ولبسط القول في بعض من هذه الإشكالات قال عبد الغاني بردي رئيس القسم المحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، إن أهمية حرية الصحافة تكمن بالأساس في بناء الديمقراطيات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حريات المواطنين بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص.
وأشار بردي إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة يؤكد أهمية حرية التعبير وحرية الصحافة في منظومة حقوق الإنسان، حيث تعتبر أساسا لعدة حقوق رئيسية أخرى، وأوضح أن الدستور المغربي يؤكد حرية التعبير، ويحترم بذلك مبادئ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في هذا السياق، أكد المتحدث أن حرية الرأي والتعبير تشمل الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في البحث عن الأخبار والأفكار، والحق في تلقيها ونقلها إلى الآخرين. وأشار إلى أن الدستور المغربي يكرس حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني… ويكفل بشكل صريح الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء للجميع.
من هذا المنطلق، دعا رئيس القسم المحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عدم حصر ضمانات ممارسة حرية التعبير في مهنة الصحافة فقط، بل يجب توفير هذه الحريات للجميع دون استثناء. وأكد على ضرورة التأكد من أن أي فعل يتعارض مع القانون يتم التعامل معه وفقا للمعايير الدولية، ولا يجب أن يتم إلقاء اللوم على مهنة الصحافة أو صحافي محدد دون مراعاة السياق القانوني.
وفي إطار تطور التكنولوجيا الحالي، أكد رئيس القسم المحدث في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ممارسات الصحافة والإعلام والنشر لم تعد حكرا على الصحافيين أو فئات مهنية محددة. اليوم، يشارك الجميع في نشر المعلومات وتبادل الأفكار والأخبار. موضحا أن هذه المبادئ ليست جديدة، إذ تكفل المادة 19 من الدستور حرية التعبير للجميع.
بردي أفاد أنه يجب إعادة النظر في المنظومة الوطنية المتعلقة بالنشر وإجراء تحديث شامل لها، وذلك بما يتوافق مع التطورات الحالية.على اعتبار أن هذا النقاش يجب أن يكون عموميا، ويشمل الجميع؛ لأن حرية التعبير هي أساس النموذج الديمقراطي في المجتمع المغربي.
وأضاف المتحدث أنه يمكن الاستفادة من التجارب الأخرى في تنظيم مهنة الصحافة والنشر، وتمكين آليات التنظيم الذاتي. وبناءً على ذلك، دعا إلى فتح نقاش جدي حول جدوى استمرار التأطير القانوني لحرية الإعلام والصحافة، وتقوية آليات التنظيم الذاتي وتقليص القيود على حرية التعبير عبر القوانين.
وأكد المتحدث نفسه على أن حرية الصحافة وحرية التعبير تعتبر حريات أساسية وأصولية، ويجب أن تكون القيود عليها محدودة وضيقة إذا اقتضت الضرورة، ويجب إثبات ضرورة هذه القيود بشكل مقنع. كما أشار إلى أن الصحافة تلعب دورًا هامًا في المجتمع وعلى ضوء ذلك يجب التعامل مع حرية الإعلام والتعبير بحذر ودقة.
وقال بردي إن الانكباب على إصلاح القانون الجنائي ينبغي أن يضمن عدم تقييد حرية التعبير، حيث يجب أن يكون القانون الجنائي منصفا ويحمي حرية التعبير للجميع. إذا تم حماية حرية التعبير في هذا الإطار، فلن تكون هناك مشكلات كبيرة، خاصة أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون.
وأوضح أن حماية حرية التعبير لا ينبغي أن تقتصر على الصحافيين فقط، بل يجب أن تشمل الجميع، وهذا يتماشى مع النص الدستوري والحماية الدولية لحقوق الإنسان. لذلك، ينبغي تحقيق روح إصلاحية في قانون الصحافة والنشر وتجنب فرض عقوبات سالبة للحرية.
وكشف أن من بين القضايا الراهنة هي قضايا التشهير، حيث يجب التفكير في إلغاء قوانين التشهير الجنائي واستبدالها بقوانين مدنية. وويجب أن تعكس قوانين التشهير أهمية النقاش العام حول القضايا العامة وينبغي أن يتم قبول درجة أكبر من النقد للشخصيات العامة، مقارنة بالمواطنين العاديين، ولا ينبغي أن تكون العقوبات المدنية كبيرة للغاية.
من جهته، قال رئيس نادي المحامين بالمغرب مراد العجوطي، إن حرية التعبير حق عالمي لا غنى عنه، ويمثل ركنا أساسيا من منظومة حقوق الإنسان، وجزء أساسيا من الحقوق المدنية والسياسية، ويرأى أن مدونة الصحافة والنشر التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2016، تعزز الحرية الصحافية وتعيد تنظيم مهنة الصحافة لتلبية احتياجات الصحافيين.
وأضاف العجوطي أن الهدف الأمثل لقانون الصحافة والنشر هو توفير أقصى الضمانات للصحافيين المهنيين، بحيث يكون بوسعهم أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وذلك من خلال إرساء دعائم الحرية وإلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بالغرامات المالية، وهو ما يحد من التضييق على الصحافة ويحمي حرية التعبير.
وأكد المحامي أن مدونة الصحافة والنشر استمدت قوتها من الدستور 2011، وتم تحسين الفصول الرئيسية لقانون الصحافة والنشر لتحقيق تقدم كبير في حماية حرية الصحافة ومهنة الصحافة، فهناك تعديلات أساسية وجوهرية طالت العديد من الفصول: فقد تم تطهير قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تقيد الحرية وإلغاء آجال الاستدعاء وتحديد آجال التقادم وتحقيق مكاسب أخرى في مجال حرية الصحافة، لكن رغم التحسينات التي تم إدخالها إلى القانون، أشار إلى أنه لا يزال هناك بعض النواقص التي يجب معالجتها لضمان تحقيق حرية الصحافة بشكل كامل وفعال.
في هذا الصدد اعتبر عبد العزيز النويضي عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء بالمغرب أن القانون الصحافة والنشر يحتوي على بعض العقوبات السالبة للحرية، على الرغم من وجود ضمانات وحماية لبعض حقوق الصحافيين كمنع الإيقاف أو الاعتقال الاحتياطي خلال المحاكمة طبقا للمادة 98، إلا أن بعض الفصول القانونية لا تزال ترتبط بجرائم مشابهة موجودة في القانون الجنائي، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات جنائية تتضمن الحبس.
وذكر المحامي أنه من بين الفصول التي تحمل عقوبات قاسية هو المادة 71 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على أنه يمكن تطبيق أحكام المادتين 104 و106 إذا تضمنت إحدى المطبوعات أو المطبوعات الدورية أو إحدى الصحف الإلكترونية، في حالة وجود اتهامات بالإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريض ضد وحدة التراب الوطني أو قذفا أو سبا أو مساسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو ولي العهد أو أي عضو في الأسرة الملكية أو الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.
وأضاف المحامي نفسه أن المشرع هنا قام ظاهريا بحذف العقوبة السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، ولكنه ضمنها في مدونة القانون الجنائي وبالتالي ففي جريمة نشر واحدة نجد عقوبة تطال وسيلة النشر وأخرى تطال الشخص الذي ارتكبها ولن يجد القاضي حرجا في تطبيق القانونين معا؛ لأن كلا منهما قابل للتطبيق على جهة محددة ودون تضارب، ولوضع حد لهذه الازدواجية تقدمت وزارة العدل ووزارة الثقافة والاتصال بوضع مشروع قانون في أكتوبر 2017 ينسخ مقتضيات من قانون الصحافة تتعلق بعدد من جرائم النشر ويحولها للقانون الجنائي، وتهم التحريض على عدد من الجرائم والإشادة بالإرهاب أو بجرائم الحرب أو بجرائم الإبادة الجمعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التحريض على الكراهية والتمييز إضافة إلى جرائم إهانة القضاة أو الموظفين العموميين أو رجال القوة العمومية أو هيئة منظمة. موضحا أن خطورة حذف هذه الجنح من قانون الصحافة والنشر تكمن في تطبيق مسطرة جنائية تسمح بالاعتقال؛ لأن المسطرة التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر لا تسمح بالاعتقال كما أن الجنح فيه لا تعاقب بعقوبات حبسية.
ودعا الأستاذ الجامعي أنه يجب أن يتم التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وحرية التعبير وحرية الصحافة، وتبني قوانين تحترم المعايير الدولية وتضمن توفير بيئة إعلامية حرة ومتنوعة.كما يجب أن تكون العقوبات السالبة للحرية محدودة ومنصوص عليها بوضوح في القانون، وأن تكون القوانين شفافة تسمح بمراجعة قضائية عادلة في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني.
على الرغم من وجود إطار قانوني يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة بالمغرب، إلا أنه لا يزال هناك عمل يجب أن يتم لتجاوز الإكراهات والتحديات التي تواجه الصحافة المغربية وتحقيق الحرية المطلقة في التعبير والنشر، وذلك لمعالجة القصور في التشريع أو في الممارسة. وعليه، أصدر مرصد الحريات وحقوق الإنسان تقريره حول انتهاكات حريات التعبير والتجمع والتظاهر والحق في الوصول إلى المعلومات بالمغرب توصيات من بين أبرز:
على المستوى التشريعي:
– ضرورة قيام البرلمان المغربي بمراجعة العديد من القوانين المعتمدة مؤخرا (قانون الصحافة وتعديلات القانون الجنائي، والحق في الحصول على المعلومات)، وذلك على ضوء المذكرات التي تم رفعها إلى الحكومة، ما بين سنة 2011 و 2015، من طرف عدد من الجهات الفاعلة المغربية والدولية، والتي لم يؤخذ مضمونها بعين الاعتبار بشكل كاف؛
– ملاءمة القانون الجنائي مع معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك من أجل ضمان الحق في حرية التعبير في المغرب. فإذا كانت القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام تضمن مستوى معين من الحماية لمهنيي قطاع الصحافة والاعلام، فإن ذلك لا يعفيهم من الامتثال لمقتضيات القانون الجنائي الذي يظل مطبقا على كل ضروب النشر والصحافة، سواء كانت مهنية أو غير مهنية، وكذلك على كل أشكال التعبير الذي أو الثقافي أو الأدبي أو العلمي؛
– إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير، التي لم يقيدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لحماية باقي الفاعلين غير المهنيين في مجال الصحافة والنشر (الصحفيون المواطنون، والصحفيون الجمعويون والمدونون،…) مع إتاحة حماية أكثر للحقوق والحريات المرتبطة بشكل خاص بالصحافة المهنية؛
– تجميع النصوص القانونية المتعلقة بحرية الصحافة في مدونة واحدة للصحافة تتضمن:
قانون الصحافة والنشر،
النظام الأساسي للصحفيين المهنيين
قانون المدونين والصحف الإلكترونية
القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري،
قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري،
القانون المنظم للإشهار.
– الدعوة إلى تنزيل الآلية المشتركة بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل حماية الصحافيين.
على المستوى القضائي:
– تكريس مبادئ استقلال العدالة والمحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في الدستور والاتفاقيات الدولية؛
– إنشاء هيئات قضائية متخصصة في قضايا الصحافة والنشر؛
– ضرورة إنشاء غرفة مختصة بقضايا الصحافة والنشر تضم قضاة متخصصين من أجل تسهيل التواصل مع الصحفيين، وتيسير التفاهم والتفاعل بينهم، لضمان عدم مساس الأحكام بقيم المجتمع الديمقراطي؛ وذلك نظرا لخصوصية قضايا الصحافة والنشر وأثرها على حرية الصحافة باعتبارها ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي الحداثي، واعتبارا لضرورة توفر القاضي الحكم المكلف بالنظر في هذه القضايا على كفاءات خاصة وإلمامه بأساسيات العمل المهني الصحفي، ومبادئ حقوق الإنسان والاجتهادات القضائية الحديثة، ومقتضيات الاتفاقيات الدولية، وتقنيات وسائل الإعلام، وفنون الرسم والتصوير الفوتوغرافي… ؛
– تعزيز بعد حقوق الإنسان في التكوين الأساسي للقضاة؛
– انفتاح العدالة على وسائل الإعلام والرأي العام من أجل كسب ثقة المواطنين عبر تحسيسهم بدور العدالة وإجراءاتها وتعزيز التواصل بطريقة مهنية ومنتظمة للرد على التساؤلات وتوضيح المزاعم والشائعات عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو وزارة العدل أو عبر ناطق رسمي لدى المحاكم، وذلك أجل توفير معلومات حول القضايا المتعلقة بالصحافة والتي تهم الرأي العام، دون المساس بالمتقاضين أو إعاقة السير العادي للعدالة؛
– الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي للقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؛
– تطبيق مبدأ التناسب بين الضرر الناجم في قضايا التشهير والأحكام الصادرة (الحبس أو التعويض)؛
– فتح تحقيق حول تفشي ظاهرة “صحافة التشهير “.